| التعليمـــات |
| التقويم |
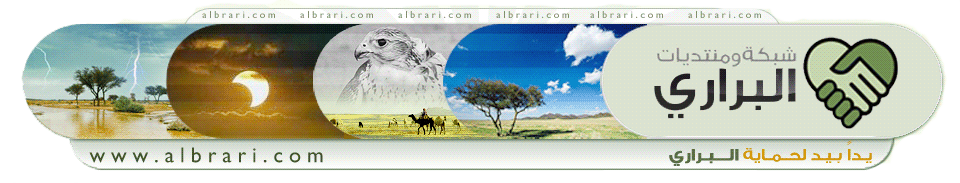
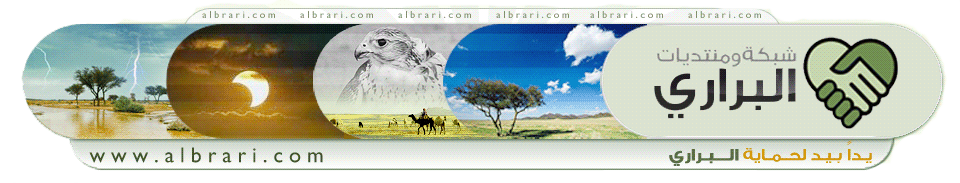 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
قال: "أقدام متعبة وضمائر مستريحة، خير من ضمائر متعبة وأقدام مستريحة"؛ فالقدم المتعبة ترمز إلى الحركة والعمل والتعب والتضحية من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى حيث مرضاة الله تعالى، بفعل الطاعات واجتناب المنكرات؛ حينها تكون الراحة والطمأنينة للقلب والضمير، وهذه قمة السعادة. بينما في الجهة الأخرى، نرى الكسل والخمول والتقاعس والتسويف؛ فما طلبه الله مؤجّل أو غير منفّذ، والعمل بطيء أو غير موجود، فما هو إلا الركون إلى الإيمان وحده وأنه موجود، فلا توجد تضحية ولا إيجابية، هنا كيف يطمئن القلب ويستريح الضمير؟ وكيف يكون الشعور بالرضا من الله وعن الله؟ وهل يستشعر العبد حينها السعادة الحقيقية، أم هو تعب الضمير والقلب؟ وإذا قلنا هذا عن المتقاعس المقصّر، فماذا نقول عن المخالف الذي ظلم نفسه ظلما كبيرا، بأن اقتحم المنكرات وأوغل فيها، ولم يقف عند حد التقصير في فعل الطاعات، بل يحاول التشكيك فيها والالتفاف عليها؟! فهذا من باب أولى قد فقد الشعور الإيماني كله، ولا يمكن وصف نفسه بأنها لوّامة فضلاً عن كونها مطمئنة، بل إن أصحاب هذه النفوس يسيرون نحو القسوة التي تنفذ إلى قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لقد كان الوصف القرآني العام للأقدام هو السير في الأرض، والعمل الصالح. ومعظم العمل يريد حركة وهمة وإقداما. ولم يذكر الله ثبات الأقدام إلا في موضوع القتال في سبيل الله، كناية عن عدم التولي والتراجع أمام العدو؛ فهو الثبات المطلوب وما يواليه من صبر، فالنصر صبر ساعة، وما يعاني منه المؤمن يعانيه العدو، وما يرجوه المؤمن لا يرجوه العدو: "ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون" (النساء، الآية 104). ولقد جعل النبي، صلى الله عليه وسلم، التولي يوم الزحف من السبع الموبقات؛ فهنا الأقدام تسير ولكن في غير مرضاة الله سبحانه، حين تكون متخاذلة وأصحابها منتكسو القلوب. حتى العلماء لا يجوز أن يبقوا حبيسي الأقلام والأوراق، ولقد قيل إنه لا بد مع القلم من قدم. ورحم الله سيد قطب وهو يفسر قول الله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة، الآية 122)؛ فالفرقة المتفقهة هي التي نفرت وتحركت وسارت، وهي أجدر بالحديث عن الإنذار والتحذير، لأنها فقهت الحياة، وشتان بين فقه الحركة الذي يقود إلى فقه الحياة، وبين فقه الأوراق وحده، فهو لن يكفي لتصور حقائق الحياة وطبائع الناس وكيفية الدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالجة النفوس واتباع المنهج الأصح في ترتيب الأولويات في الحياة على مختلف مستوياتها. ويقال في هذا المعنى: "من تعرض للمصاعب ثبت للمصائب"؛ فالذي تعرض للمصاعب تحرك وتفقه وتعلم من مدرسة الحياة، فهو أجدر بالثبات عند المصائب والفتن والمحن والابتلاءات. ونعلم أن الدنيا كلها دار ابتلاء، فيها من التنغيص والآلام ما فيها، فهي متقلبة لا تصفو على حال، والله سبحانه وعد بابتلائنا وفتنتنا حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والصابر من الضاجر. وكذلك قيل: "من لم يركب الأهوال لم ينل المطالب"؛ فالمطالب العالية السامية لا بد لها من التشمير عن اليد وكشف الساق وركوب الأهوال. وكلما زاد سمو المطلب كانت الهمة أعلى، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة". والدلجة هي السير في أول الليل، وقيل في آخره، ففيه نشاط على المسير وقوة؛ فمن خاف عقاب الله وخاف عذاب النار جدّ في الطلب واستمر واستقام ولم يتراجع، وحينها بلغ المنزل وهو الجنة. يقول المتنبي: "فإني أستريح بذا وهذا... وأتعب بالإناخة والمُقام". ويقصد بذا وهذا الحركة. ويقول شوقي: "وما نيل المطالب بالتمني... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا". وكلام الأدباء وشعرهم يطول في هذا المقام، وغايتنا أن نفرق بين كوننا مؤمنين بالله تعالى ولكننا مقصرون في السعي والعمل والأخذ بالأسباب؛ فالكون محكوم بسنن لا تحابي أحدا، فللنصر أسبابه وللنجاح أسبابه وللعزة أسبابها وللرزق أسبابه، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكل ذلك بمشيئة الله، وفق حكمته وقضائه؛ فقد ييسر الشيء وقد يُبعده، فهو وحده الذي يعلم حقائق الأشياء ومآلاتها، وما هو أصلح للإنسان، وسبحانه وهو يجلي الحقيقة بقوله: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (البقرة، الآية 216). إن الأمة الآن في مرحلة صحوة من غفوة طال أمدها، وفي مرحلة نهضة من كبوة طال عهدها وأورثت كسلاً وهزيمة نفسية. ومطلوب من كل ذي علم وغيرة على الأمة والدين أن يبذل الخير ويدفع الشر، ولو بالكلمة الطيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم"، ونقرأ كلمة "أهلكهم" بفتح الكاف وضمها، وهي على الوجهين مرعبة، فمن قال هلك الناس وكان سلبيا بإشاعة ذلك فهو سبب في إهلاكهم، أو هو أهلكُهم أي أشدهم هلاكًا، وذلك حين تقاعس ولم يقدّم شيئًا لدفع أسباب هذا الهلاك. ومرة أخرى، فالمطلوب دفع باتجاه نصرة هذه الأمة التي تملك من مقومات النهوض ما لا تملكه أي أمة أخرى، ويكفينا وعد الله ووعد رسوله في حتمية انتصار هذه الأمة. ولكن حتى لا نقع في الخطأ نفسه، فالمطلوب عمل وتضحية وأخذ بالأسباب، لا الوقوف عند أمجاد التاريخ، أو الجمود عند مبشرات القرآن والسنة. *أكاديمي أردني د. محمد المجالي* نشر : 09/11/2012 الساعة 00:00 am(GMT +2)
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
من يعتاد على النشاط والحيوية
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
بارك الله فيك ورعاك
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
طرح قيم الله يعطيك العافيه اخي الكريم
|
 |
|
|