| التعليمـــات |
| التقويم |
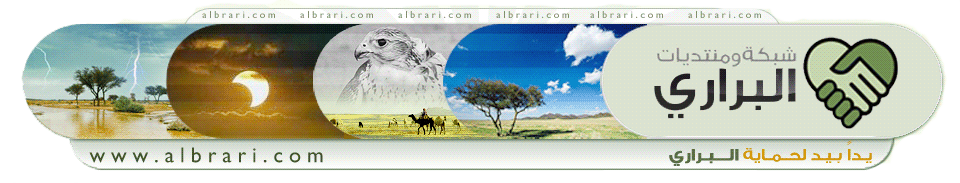
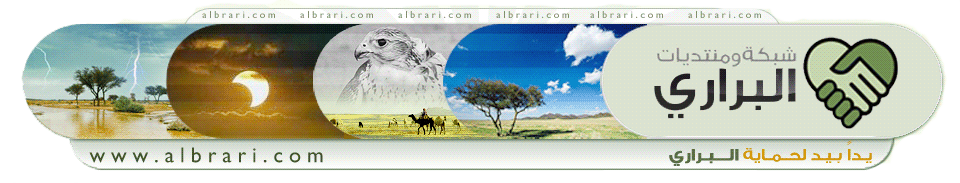 |



|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
جولة في رياض الحضارة (1/2) *** شروط قيام الحضارة :لا شروط عرقية لقيام الحضارة ، إذ يمكن أن تظهر في أية قارة ، يقول توينبي Toynbee : (لا يوجد عرق متفوق بدأت الحضارة عن يده). ونظرية توينبي تقول : إن تقدم الحضارة ، كان نتيجة رد فعل للتحدي في الظروف الصعبة التي تدفعه إلى بذل أكثر ، ومثال ذلك (الصحراء الكبرى) ، التي كانت سهولاً خصبة ملأى بالأعشاب والمياه ، وبتغير الظروف المناخية – وهي التحدي هنا – سلك السكان طرقاً ثلاثاً استجابة لهذا التحدي : 1- فبعضهم ظلوا مقيمين في الصحراء الكبرى ، وبدلوا عاداتهم ونمط معيشتهم إلى بدو رحل. 2- وآخرون انتقلوا إلى المناطق المدارية جنوباً حيث الغابات ، وحافظوا على حياتهم البدائية. 3- وآخرون دخلوا مستنقعات وادي النيل وغاباته ، كما دخلوا الدلتا ، وقبلوا التحدي ، وعملوا على تجفيف المستنقعات وإعدادها للزراعة ، وأتوا بالحضارة المصرية القديمة. وكذلك الحضارة السومرية في دلتا دجلة والفرات ، وكذلك حضارة الصين في وادي النهر الأصفر (هوانغ هو) ، ولا ندري تماماً ما نوع التحدي ، ولكن الأحوال كانت صعبة. والحضارة الإيجية المينوسية ، كان أصلها تحدي البحر للسكان. فالأحوال الصعبة المعاكسة ، وليست الأحوال المواتية ، هي التي تنتج الحضارات ، وهذا ما يسمى (حافز الصعوبات) ، أو (دافع البلاد ذات الأحوال المعاكسة). ثم يقول توينبي : (إن الأرض الجديدة تثير الهمم ، والأرض البكر تولد رد فعل أقوى من ذاك الذي تولده أرض ذات حضارة سابقة ، فالحضارات التي أتت بتأثير ما سبقها ، نرى أن مظاهرها القوية كانت في مناطق خارجية عن نطاق الحضارة الأصلية التي سبقتها). ويتساءل مستدركاً في نظرية التحديات هذه : أيجب أن يكون رد الفعل أعظم كلما كان التحدي أشد ؟ أم إن هناك تحديات شديدة جداً لا تأتي بأي مفعول معاكس ؟ ويجيب بأن بعض التحديات قضت على المجتمعات التي لاقتها ، ولكنها أخيراً أدت إلى رد فعل مناسب من مجتمع آخر ، أو من جهة أخرى ، مثل الاجتياح الهيليني للشرق ، أدى إلى ردود فعل مخفقة ضدها ، فظهرت الزردشتية. وهناك (حضارات عقيمة) ، لم يكن لها ما بعدها ، حاولت أن تأتي بحضارة من عندها ، كمنافسة لحضارة أعظم ، فنجحت مؤقتاً ، ولكنها انحطت وزالت من الوجود ، مثل الحضارة الكلتية في غربي أوربة ، ودامت حتى عام 375م ، ثم قضت عليها سلطة رومة الدينية ، ثم سلطة إنكلترة السياسية. ويمكن القول : إن الطبيعة ليست عدواً في كل الحالات ، فهي التي هيأت المناخ المعتدل ، والتربة الخصبة ؛ فإن كان التحدي يعني الإثارة فهذا مقبول. فالقحط تحد ، أو إثارة ، أوجب بناء السدود. والتصحر تحد ، كون تثبيت التربة. وتزايد السكان تحد ، سبب استصلاح الأراضي. ومشروط قيام الحضارة بطائفة من العوامل ، منها ما يستحث خطاها ، ومنها ما يعيق مسارها ، ومن هذه العوامل : 1- العوامل الجيولوجية : فعصر الجليد أعاق مسارها ، والتربة الخصبة استحثت خطاها. 2- العوامل الجغرافية : المناخ المناسب يستحث خطاها ، ولكنه لا يخلق حضارة خلقاً ، إلا أنه يستطيع أن يبتسم في وجهها ، ويهيئ سبيل ازدهارها وتقدمها ، وحرارة المناطق الاستوائية المرتفعة ، وما يجتاح تلك المناطق من أمراض لا تهيئ للحضارة أسبابها ، وهي بالتالي لا تستحث خطاها. 3- العوامل الاقتصادية : ( تبدأ الحضارة في كوخ الفلاح ، ولكنها لا تزدهر إلا في المدن) ، قد يكون لشعب مؤسسات اجتماعية منظمة ، وتشريع خلقي رفيع ، بل قد تزدهر فيه صغريات الفنون ، كما هي الحال مع الهنود الحمر ، ومع ذلك فإنه إن ظل في مرحلة الصيد البدائية ، واعتمد في وجوده على ما عسى أن يصادفه من قنائص فإنه يستحيل أن يتحول من البدائية إلى الحضارة تحولاً تاماً. إن الإنسان لا يجد لحضارته ( لتمدنه) معنى ومبرراً إلا إذا استقر في مكان يفلح تربته ، ويخزن فيه الزاد ليوم قد لا يجد فيه مورداً لطعامه ، في هذه الدائرة الضيقة من الطمأنينة ، والتي هي مورد محقق من ماء وطعام ترى الإنسان يبني لنفسه الدور والمعابد والمدارس ، ويخترع الآلات التي تعينه على الإنتاج ، ويستأنس الحيوان ، ثم يسيطر على نفسه آخر الأمر ، فيتعلم كيف يعمل في نظام واطراد ، وكيف يزداد قدرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخلاق نقلاً أميناً. (إن حاجة بعض الناس إلى بعض ، صفة لازمة في طبائعهم ، وخلقة قائمة في جواهرهم ، وثابتة لا تزايلهم ، ومحيطة بجماعتهم ، ومشتملة على أدناهم وأقصاهم ، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم – مما يعيشهم ويحييهم ، ويمسك بأرماقهم، ويصلح بالهم ، ويجمع شملهم ، وإلى التعاون في درك ذلك ، والتوازر عليه – كحاجتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم ، والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي لم تغب عنهم). 4- يضاف إلى ما سبق من عوامل ، العوامل النفسية التي تسرع في تقدم الحضارة ، إن العوامل الجيولوجية ، والجغرافية والاقتصادية لا تكون حضارة ، ولا تنشئ مدنية من عدم ، إذ لا بد أن يضاف إليها العوامل النفسية ، ولا بد أن يسود الناس نظام سياسي ، وحالة استقرار ، وربما كان من الضروري كذلك أن يكون بين الناس بعض الاتفاق في العقائد الرئيسية، وفي المثل الأعلى المنشود ، لأن ذلك يرفع الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره ، إلى مرحلة الإخلاص للعمل ذاته ، وهو كذلك يجعل حياة الإنسان أشرف وأخصب. لو انعدمت هذه العوامل ، أو واحد منها ، لجاز للحضارة أن يتقوض أساسها ، فانقلاب جيولوجي خطير ، أو تغير مناخي شديد ، أو استنفاد للموارد الطبيعية ، أو تغير في طرق التجارة تغيراً يبعد أمة عن الطريق الرئيسية للتجارة العالمية ، أو انحلال خلقي ينشأ عن الحياة في الحواضر بما فيها من منهكات ومثيرات واتصالات ، أو ينشأ عن تهدم القواعد التقليدية التي كان النظام الاجتماعي يقوم على أساسها ، ثم العجز عن إحلال غيرها مكانها - هذه من الوسائل التي قد تؤدي إلى فناء الحضارة ، (إذا الحضارة ليست شيئاً مجبولاً في فطرة الإنسان ، كلا ، ولا هي شيء يستعصي على الفناء ، إنما هي شيء لا بد أن يكسبه كل جيل من الأجيال اكتساباً جديداً ، فإذا ما حدث اضطراب خطير في عواملها الاقتصادية ، أو في طرائق انتقالها من جيل إلى جيل ، فقد يكون عاملاً على فنائها ، إن الإنسان ليختلف عن الحيوان في شيء واحد ، وهو التربية ، ونقصد بها الوسيلة التي تنتقل بها الحضارة من جيل إلى جيل). *** اتصال الحضارات وانتقالها :يتم الاتصال بين الحضارات ، وبالتالي انتقالها عن طريق : الغزو أو الفتح ، أو الحكم الأجنبي ، أو الهجرة والسياحة والتجارة والحوار، ومثال ذلك (الهيكسوس) ، الذين غزوا مصر ، وعاملوا أهلها بشدة وعنف ، لكنهم ما لبثوا بعد مدة من الزمن أن أخذوا يتعودون على الحياة المصرية ، وجرفهم تيار حضارتها فتمصروا وقلدوا الفراعنة في أسمائهم وألقابهم وأزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم الملكية ولغتهم ، وقدموا القرابين إلى الآلهة المصرية ، وسموا أنفسهم (أبناء رع). ونميز في حالات الاتصال هذه ، نوعين رئيسيين من انتقال الحضارة : 1- إذا كان الشعب المهاجم في حال بدائية ، أي حضارة الشعب المهاجم الذي ساد البلاد وحكمها دون حضارة الشعب المغلوب ، فتحصل فترة توقف في مسيرة الحضارة الأصلية ، كالهيكسوس ، والبرابرة والجرمان ، والتتر ، ففي مثل هذه الحال تهضم حضارة المغلوب الغزاة المنتصرين ، وتردهم – ولو بعد حين – وقد اقتبسوا حضارة الشعوب المغلوبة. 2- أما إذا كان الشعب الفاتح في حال فكري أرقى ، كالفاتحين العرب والمسلمين، فعندها تزدهر حضارة رائعة بعد الفتح والاستقرار ، مع طبع الحضارة بطابع الفاتحين الخاص. وقد يحصل تبادل حضاري بين طرفين حضاريين ، وقد يعطي الشعب المغلوب إلى الشعب الغالب أكثر مما يأخذ منه، مثال ذلك اليونان عندما حكمهم الرومان، والصليبيون عندما وصلوا بلاد الشام ، واطلعوا على الحضارة العربية الإسلامية. وقد يتم الانتقال عن طريق طرف آخر ، فالحضارة العربية الإسلامية انتقلت إلى أوربة عن طريق المدن الإيطالية ، وصقلية ، ومدن فرنسة الجنوبية ، والأندلس. *** مظاهر الحضارة :للحضارة عناصر تتألف منها ، ومظاهر متعددة تظهر بها : 1- المظهر السياسي : ويبحث في هيكل الحكم ، ونوع الحكومة ، ملكية أم جمهورية ، دستورية أم مطلقة ، والمؤسسات الإدارية والمحلية. والدولة تنشأ بسبب ضرورة النظام ، ولا يعود بالإمكان الاستغناء عنها ، وتصبح الدولة وسيلة للتوفيق بين المصالح المتباينة التي تكون مجتمعاً مركباً، ويرى ول ديورانت أن (العنف هو الذي ولد الدولة) ، وأن الدولة هي نتيجة الغلبة والفتح ، وتوطد نفوذ الغالبين ، كطبقة حاكمة على المغلوبين. 2- المظهر الاقتصادي : ويبحث في موارد الثروة ، ووسائل الإنتاج الزراعي والصناعي ، وتبادل المنتجات. 3- المظهر الاجتماعي : ويبحث في تكون المجتمع ونظمه ، وحياة الأسرة ، والمرأة ، وطبقات المجتمع ، والآداب ، والأعياد. 4- المظهر الديني : ويبحث في المعتقدات الدينية ، والعبادات ، وعلاقة الإنسان ونظرته إلى الكون والحياة. 5- المظهر الفكري : ويبحث في النتاج الفكري ، من فلسفة وعلم وأدب. 6- المظهر الفني : ويبحث في الفن المعماري ، والرسم ، والموسيقى ، وغيرها من الفنون. *** مصادر الحضارة :إن الكتابة أهم وسيلة لحضارة الإنسان ، وحيثما وجدت الحضارة وجدت القراءة والكتابة ، وأصبحت اللغة المكتوبة وسيلة الحضارة والعلم والتربية ، فالكتابة تعطي المعرفة البشرية صفة الدوام ، والبراهين عن حضارة الإنسان القديم قليلة حتى نصل إلى عصر الكتاب ، ووضع الوثائق المكتوبة ، ولهذا السبب احترم القدماء الكتابة ، ونسبها المصريون القدماء إلى الإله توت Thoth ، فهو – في رأيهم - مخترع وسائل الثقافة جميعها ، وفي بابل كان الإله نبو (Nebo) بن مردوخ إله الكتابة ، والصينيون القدماء ، والهنود وغيرهم ، اعتقدوا بأصل إلهي للكتابة ، والأساطير اليونانية نسبتها إلى هرمس. وبوجه الإجمال كان للكتابة مفعول سحري على الناس ، فاختراع الكتابة أهم من اللغة ، لأن اللغة ليست اختراعاً بشرياً كالكتابة ، وإنما هي ميزة بشرية. الكتابة: وسيلة لنقل الكلام ، تسجل أصواتاً آتية من الفم ، أو فكراً آتية من الدماغ ، برموز منظورة على الورق ، أو الحجر ، أو الخشب ، أو غيرها. ومن الصعب تحديد دقيق لوقت معين لبدء الكتابة ، ولكن لا برهان على وجود كتابة منظمة قبل منتصف الألف الرابع قبل الميلاد ، وكانت كتابة تصويرية Pictography ، حيث الصورة تمثل الشيء الذي يراد ذكره ، فالدائرة تمثل الشمس ، وصورة الحيوان تدل عليه. ثم جاءت الكتابة الفكرية (أو الرمزية) Ideographic ، وهي أرقى من التصويرية ، لأنها تصور الأفكار التي يراد نقلها من شخص إلى آخر ، فالدائرة لا تمثل الشمس فقط ، بل تمثل النهار ، أو النور ، والحيوان لا يمثل بصورة الحيوان وإنما برأسه فقط ، وفكرة الذهاب تمثل بقدمين ، أو بخطين يمثلان قدميه ، والرموز المستعملة هنا تسمى صوراً فكرية Ideographic ، ويمكن قراءة الرموز في أية لغة في هاتين المرحلتين – التصويرية والفكرية ، إذ لا علاقة بين الرمز وبين اسم الشيء الذي يمثله. ثم جاءت مرحلة الكتابة ذات المقاطع ، وهي صوتية ، بمعنى أن كل رمز أو صورة لها صوت في اللغة الخاصة التي تكتب بها ، والرموز التي لها أصوات معينة ، يمكن جمعها بأشكال مختلفة لإخراج كلمات وفكر مختلفة ، وهي لا تمثل الأشياء والفكر فقط ، وإنما الأصوات ، وتصبح الكتابة صوتية تماماً عندما تصبح الأشكال المكتوبة ثانوية بالنسبة للكلمات التي تلفظ ، وتفقد تلك الأشكال مدلولها الأصلي حينما تجتمع لتشكيل كلمة أو فكرة جديدة ، بمعنى أنها تصبح قسماً أو مقطعاً من كلمة ، فكلمة (درفيل) مثلاً ، مكونة من مقطعين (در) و (فيل) ، ولكل منهما معناه ورمزه ، فإذا اجتمعا لتكوين كلمة واحدة يفقد عند ذلك المقطعان مدلولهما الأصلي، ويصبح كل منهما صوتاً أو مقطعاً في كلمة جديدة. أما الكتابة الأبجدية ، وهي أرقى أنواع الكتابة وأنسبها وأسهلها ، فهي آخر المراحل في تطور الكتابة ، وفيها توجد حروف تمثل أصواتاً مفردة ، لا مقاطع وفكراً ، والأبجدية التي اكتشفت في سيناء ، وأبجدية رأس شمرا (أوغاريت) ، هما أقدم الأبجديات في العالم ، وترقى أبجدية رأس شمرا إلى القرن الرابع عشر الميلاد، ومنها اقتبست الأبجديات التي تستعملها معظم شعوب العالم في أيامنا هذه. ويعد اختراع الأبجدية بالنسبة للبشرية موازياً لأهمية اختراع المطبعة ، بعد ثلاثة آلاف سنة ، إن لم أكثر أهمية. يقول الجاحظ : ( لولا الكتب المدونة ، والأخبار المخلدة ، والحكم المخطوطة التي تحصّن الحساب وغير الحساب ، لبطل أكثر العلم ، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر ، ولما كان للناس مفزع إلى موضع استذكار ، ولو تم ذلك لحرمنا أكثر النفع)، ويقول : ( وليس في الأرض أمة بها طِرق – قوة – أو لها مُسكة ، ولا جيل لهم قبض وبسط ، إلا ولهم خط). والوثائق المكتوبة ، وهي تجمع السجلات الصكوك والمراسلات .. مع الآثار المادية كالأبنية والبقايا الفنية ، والأواني ، والأدوات ، والأسلحة ، هي مصادر الحضارة. ويزداد شأن الآثار في التاريخ كلما أوغلنا رجوعاً في الزمن ، لتصبح في بعض الأحوال ، وفي العصور القديمة خاصة ، مصادر التاريخ الوحيدة ، فالشعوب كلها بدافع من العقائد الدينية في الغالب ، أو من رغبات الملوك ، أو من الحاجات الحياتية الأخرى ، تركت آثارها على الأرض التي عرفتها ، وعلى هذه الآثار نبني معارفاً عن الحضارات القديمة. والكتابات الأثرية هي وثائق العصور القديمة ، فمعظم الحضارات السالفة سجلت على آثارها ما تريد قوله بكتابات شتى ، فحين حل شمبليون (Jean – Francois champolion) رموز الهيروغليفية ، أضاف إلى التاريخ ثلاثة آلاف سنة ، والكتابات التي استعصت على الحل – مثل كتابة كريت – ما تزال تحتفظ بأسرار التاريخ. وهكذا عصور ما قبل التاريخ وحتى سنة 3200 ق.م حيث اختراع الكتابة في مصر، فإن مصادرنا عن الحضارة هي الأدوات ، والبقايا المادية فقط ، لعدم وجود كتابة ، ومن هنا تظهر أهمية علم الآثار ، والحفريات الأثرية التي أصبحت اليوم تستهدف الفوائد العلمية ، والاستنتاجات التاريخية ، وليس مجرد البحث عن العاديات – المكتشفات الأثرية - ، إذ العاديات لم تعد غاية في ذاتها ، وإنما وسيلة لمعرفة الحضارات وتطورها. فالكتابة تروي لنا التاريخ السياسي والعسكري ، والحياة الاجتماعية والفكرية ، والاقتصادية والدينية ، وهذا ما كان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا – تقع إيبلا جنوبي حلب ، قامت في الألف الثالث قبل الميلاد-. ومع هذا كله ، يستفيد التاريخ اليوم من كشوف الانتروبولوجيا ، وعلم الاجتماع ، واللغويات وعلوم الاقتصاد والإحصاء والتقاليد والطب وغيرها من العلوم ، إن التاريخ يحاول بذلك ، كله أن يحتضن الإنسان بكل أبعاده ، شريطة أن يعرف المؤرخ كيف يستنطق تلك الوسائل ، وهذه العلوم. كتاب الحضارة العربية الإسلامية ، للدكتور شوقي أبو خليل
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|